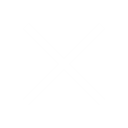تحضرني في هذه اللحظة أسئلة الباحثين الغربيين عن امتناع الصروح الجامعية من احتضان الفكر الفلسفي اللبناني، وعن تخاذل المفكرين، الّا يسيراً منهم، عن نبش الماضي القريب والبعيد، لرفع الحجاب عن الفكر الذي منه جبلت هويتنا، علماً أنه من شواطئ بلادنا كان الحرف، وكانت، بالتالي، الأبجدية، فتلازم العقل والكتابة، وصار “اللوغوس” هو العقل المكتوب. فمن ” المعين في دراسة القضايا الجلية” لفرفوريوس الصوري، إلى “الجمع بين اللاهوتي والفلسفة العددية” ليمبخيوس العيطوري، من بلدة كلسيس، أو مجدل عنجر اليوم، إلى المدرسة المارونية في روما، حيث ممارسة الحق في الجدل الفلسفي أعاد تموضع الحجر الأساس في بناء الفكر اللبناني، وقد إشتدّ عصبه في القرن التاسع عشر، واحتشدت في نهضته مفاهيم، وبرزت فيما بعد عمارة فلسفية لبنانية جديدة، اسس لها كمال يوسف الحاج، وكلها، تميزت بنزعتها التوفيقية في جمع المتناقضات في بوتقة لبنانية من دون الازاحة، قيد أنملة، عن التوفيق بين المثالية والواقعية،
ولما شملني الشرف الأثيل بأن أكون أول أستاذة لكرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية، أردت له ان يكون المنبر الواعد لإحياء الفلسفة اللبنانية، رداً على من يدعي أن اللبنانيين، ومعهم البيئة العربية، عاجزون عن مشاركة العالم في دنيا الفلسفة، وتحفيزاً لاستعادة الفلسفة منزلتها الروحية، وإسهاماً منها في تخصيب الحضارة الإنسانية، وذلك، لأننا، نحن اليوم، “في حاجة إلى فكرٍ واعٍ […] نحن في حاجة الى أن نعمل مفكرين ونفكر عاملين، فنحن في حاجة إلى فلسفة لا إلى ألسنة تلعلع من على المنابر”. (خطبة، من نحن، القيت في الجامعة الامريكية في بيروت في ١٠/٥/١٩٤٥ – كمال الحاج).
و كلّ ذلك في سبيل إضفاء معنى على ذاتنا وعلى وجودنا، وعلى العالم الّذي نعيش فيه، عن طريق الفلسفة وفي فضائها.
العودة الأولى: مَنْ نحنُ؟
لا ضير في الأمر إن استحضرنا لبنان التّاريخ وأقمنا على هذا المغيّب قسرًا مشروعًا تأسيسيًّا قصدًا، فليس ما يحول دون أن يبتدع المفكر مساحة مترسّلة للحق، و ان يستجيب له الفكر بثورة العقل العقل على أحابيل الخطأ، فتقوم العمارة الفلسفيّة اللّبنانيّة صنوًا للعمارة الفلسفيّة العالميّة… و تتغيّر الأمور لا محال.
تتأسّس العودة الأولى على عمليّة بعث لفلسفة شعب بأكمله، ركنها الرّئيسيّ العقلانيّة الهادفة الى الموازنة بين الأضداد. وأين الغرابة في مثل هذه الرؤية السبّاقة والداعية الى التاريخ العادل، وفي الأمس القريب، تمّ إعلان “وثيقة
الأخوة الإنسانية”، في أبو ظبي، بين الأزهر الشريف والكنيسة الكاثولكيّة، وأبرز ما جاء فيها اعتماد عقلانيّة واقعيّة بعيدة عن المغالاة والتطرف، “تبني ثقافة الحوار دربًا، والتعاون المشترك سبيلا، والتعارف المتبادل نهجًا وطريقًا”، و[تطالب]بنشر ثقافة التسامح والتّعايش والسلام” و[تتوجّه] الى الفلاسفة والمفكرين ورجال الدين والفنانين والمبدعين “ليعيدوا اكتشاف قيم السلام و العدل و الخير و الجمال…” و[تشدّد]على أسباب أزمة العالم اليوم شأن “تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق الدينيّة (…) و استدعاء النزعة الفرديّة والفلسفات الماديّة الّتي تؤلّه الانسان، و تضع القيم المادية الدنيوية موضع المبادئ العليا و المتسامية” .
السنا في لبّ همّ الحاج الذي به نصطفي ما هو مشترك بين جميع الاطراف؟
لقد تجاوبت العودة الأولى مع وضع الحاج العقل في مرتبة الحسّ السليم، (تجدر الإشارة هنا الى أن الحاج ليس غريبًا عن مضمون مقالة ديكارت في “المنهج” )، بتلازم منسجم مع الواقع اعتبارًا منه أن الانسان يصمّم عيشه كما يريده، وهذه الإرادة العاقلة الحكيمة تتلازم مع الإيمانيّة، وإن بدا مثل هذا التلازم موضوع تساؤل واستغراب عند البعض، سنوضح أن هاجس كمال يوسف الحاج، من حيث إصراره على المبدأ الايماني، الّذي يشاؤه للفلسفة اللبنانية، يتجسّد في أمرين: الأوّل يعتبر “الدّين في لبنان موجوداً منذ ما قبل التاريخ، و اللادين فرع”، والثاني يعتبر “أنّ الدين وحده هو الثّابت فوق أرضنا”. وعليه تكون عِلمانيتُنا مُحاوِر للعَلمانية المنفتحة التي هي في صلب فلسفة الكرسي.
وإن الإعتراض على هذه النظريّة يتطلب دعوة العقائديّين و الإيديولوجيين، وأهل الحسم في ميادين الفلسفة، ومهندسي الأنظمة السّياسيّة، الّتي اتخمت لعقود، لا بل لقرون، أجيالا من المتلقين المنفصلين قصرا عن جوهرهم الانساني، لنتقاسم معهم الإجابة على “الليش”، في مشهد سريع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، سأتناول رأي بول ريكور : “عندما ينتهي العالِم من بحثه و ملاحظاته، فليعطِ الكلام للفيلسوف، و عندما ينتهي الفيلسوف من أسئلته و نظرياته، فليعطِ الكلام للشاعر، وعندما ينتهي الشاعر من أحلامه ومشاعره وإلهاماته، فليعطِ الكلام للّاهوتيّ”.
واسأستلّ من اللّاهوتيّ الألماني كارل راهنر هذه العبارة: “حيثما يبدأ الانسان بالسؤال بعد الأسئلة، و حيثما يسمو الى ما فوق الموجود، فيحيا اختبار التعالي، يبدأ فعل التديّن. إذ ذاك يكون الانسان كائنًا دينيًّا، لا مجرّد امرئ ماديّ و زمنيّ”.
و سأستعين بأقوال غاندي المأثورة:” إنّ الحياة بدون دين هي حياة بدون مبادئ، والحياة الّتي تخلو من المبادئ تشبه مركبًا من غير دفّة.”
ومن أقوال جورج ادوارد مور:”إن الفيلسوف المثالي ينسب عدم التمييز يبن الادراك وموضوعه إلى مقولات ومفاهيم ومكتسبات المثالي المعبّر عنها كالتالي: “الكون روحاني” و”الحقيقة روحانية”.
ونستنتج منالاستشهادات السابقة “ان لا جوهر [إن لم تربطه] بالوجود حركة جدلية، ولا قيمة ان لم ترتبط بالإنسان من حيث هو جوهر او عقل، من حيث هو وجود أو إحساس، حتى لا يتهافت معنى الانسان”.
في “من نحن؟”، نستمد من تمييز كمال الحاج بين تاريخ لبنان ولبنان التاريخ، فصله بين الوعي المتأخر عن وصفه التاريخي وبين أزلية الوعي القائم على لبنان التاريخ، على ما هو فوق الفوق المعاش، إن لبنان التاريخ فوق الانتقائية واللاتاريخية، وهو أكبر من اللبنانيين… لانه الوطن الرسولي القائم ابداً في ربيع الحقيقة، ورسولية لبنان موجهة الى اللبنانيين في الداخل، والى العرب في الخارج، و الى جميع الشعوب في الارض.
في “من نحن؟” نعود مع كمال يوسف الحاج الى مغامرة لبنان التاريخ في مقاومته التصحّر المعرفي، وفي محافظته على صحته الذهنية، في كل مرة كانت تطفو فيها الاورام العقلية، وفي تشجيعه أبناءه ليشربوا مما يشرّعونه بنفسهم ولنفسهم، فالفلسفة ليست وقفاً على شعب دون آخر، وبلغة شعب دون آخرى.
في “من نحن” نتبين مع الحاج أن الفلسفة منهج تفكير لا أكثر، “والدين أرسخ وجوداً، واثبت جذوراً، وأينع ثماراً. وأبعد حساباً. وأضمن خلوداً. وألصق بالنفس البشرية”، وأن “لبنان عقل”، فبالفلسفة التي تنبع من ارضه وترشح من سمائه، يدرك اللبنانيون هويتهم […]،فيطلون على العالم بالفل والسف، أي التكسير والتركيب، وقاعدتها الأساسية “أنا” متجذّرة متجدّدة مشاركة، “إنسانها يهدُم خارجه ليبني داخله، يهدم القشور في تراثه ليبني اللّب من تراثه، يهدم بيساره ليبني بيمينه، يهدم نفسه بنفسه لئلا يهدمه غيره”(الحاج، مج١، ص٢٤) ليفهم الاجتماع الإنساني أن الفلسفة لا تستورَد، شأنها شأن القوميات التي تنبت من الأرض والإنسان والحضارة الخاصة به.
إن مقاومة هذا التأصيل الفلسفي ترتطم بفلسفة تصدمها وتحدّ من فعاليتها، إذ إن الحاج ليس يتيماً في قومنته الفلسفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر،ساستشهد بأنور عبد الملك لدى ملاحظته غياب صياغة نظرية متماسكة تتيح تحديد الإنسان المصري في مطلع انبعاثه القومي، أي تحديد من هو، ومن يريد أن يكون، فرأى أن هذا التغييب القسري لصورة الإنسان المرغوب في تحقيقه، يندرج في إطار نقص أوسع، عنوانه انعدام فلسفة الثقافة القومية. (عبدالملك،١٩٤٢-١٩٤٧) وعليه، يدعو انور عبد الملك المصريين ليعرفوا حقيقتهم، وهويتهم الحضارية، وليسألوا نفسهم أولاً “من نحن” […]
وفي السياق عينه طالب طه حسين بالكفّ عن شراء معالم العصر من الآخرين، ودعا لأن تكون مصر مشاركة فاعلة في صنع هذه المعالم، وفي تجديدها وتقدّمها المستمرين!
كما تساءل بدوره زكي نجيب محمود عن الأصالة التي تشكّل في مفهومه مجموعة الجوانب الثقافية التي نبتت في تربة الوطن كنتيجة لما ابتدعته عقولنا ومشاعرنا وقرائحنا نحن دون سوانا، واستفهم عن أسباب رفض الآخر، متسائلاً:أفليس هذا الأصيل وذلك المنقول اللذان ننسج [منهما] حياتنا، الجديدَ لحمة وسدى؟
إن هذه الرؤى تؤكد على ضرورة تثبيت مكانة الفلسفة في المجتمع اللبناني و العربي، لنؤكد على إمكانية استمرارنا في الوجود الإنساني، فما قيمة الإنسان لو سمع ألحان غيره ولم يصرخ يوماً ليسمع لحنه؟”
العودة الثانية : الهوية
قد ينتفض البعض وقد يستاء آخرون، ولكن فلسفة الصبر في غاية الأهمية لأن القضية أكبر بكثير من الاستياء غير المبرّر… فشئنا أم أبينا، الحاج هو فيلسوف القومية اللبنانية في وجه القوميات الهاضمة للوجود والتاريخ، وفي وجه أخرى ملغية للآخرين بصهرها المجتمعات في أتون الايديولوجيات العقيمة، وهو، بالتالي، حكيم الأمة العربية، ومنقذها من التلاشي والذوبان في هوية آحادية عنصرية فاتكة بالكرامة الانسانية.
مع الحاج نستعيد هوية من صنع الفكر الذي يحمل رسالتنا الفلسفية الهويتية نحو الشعوب العربية، وأبرز مظاهر هذه الرسالة تجلّى في نحت مصطلح “النصلامية” الجامع بين النصرانية والإسلام في قومية واحدة، انتقائية الاتجاه وتوفيقية، تفلسف لوجودنا تجاوباً مع رسالة لبنان التاريخ العصي على الغلبة والموت. ألم تتضمن “وثيقة الأخوة الانسانية” البعد التوفيقي الجامع للديانتين الكبريَين في العالم؟
وإن حشر أحدهم الحاج في خانة الوطنية الضيقة أو ألحق به شوفينية بغيضة، فهذا يعني أنه لم يفهم أو لا يريد أن يفهم، البعد المفتوح على وطنية معقلنة، مهذبة، متأصلة، رحبة، ولم ينتبه إلى النوافذ والأبواب المشرّعة التي تثري المجتمع سماحة واعتدالاً.
في إعتبار الحاج الفلسفة مشروعاً سياسياً، وفي إعتباره السياسة تحقيقاً فلسفياً، اعطى الحاج الفيلسوف الحقّ في أن يهيئ مناخاً فكرياً يسهم في إحداث التحويل الإجتماعي الضروري والملح والمناسب لقومه. فهل نلوم إنساناً اتخذ الفكر سماءه وأرضه وعالمه، وآمن أنّ بالفكر وحده كنا ونكون وسنظلّ كائنين؟
نحن في زمن الإياب إلى الأغورا اللبنانية، التي منها انبثقت النظرة الفلسفية القائمة على الربط الحتمي والمصيري بين قيام الدولة وتحقيق القومية، وعلى تعزيز القومية الحقوقية، التي بدورها تربط بين المفهومين السابقين، وتضع القومية في إطارها الفلسفي القويم، بلوغاً لإرساء الكيان المستقل في علاقاته الخارجية، والسيد على شؤونه الداخلية.
في مثل هذه الفلسفة المنطلقة من مبدأ الحرية، يحرّر الحاج القومية اللبنانية من “التاريخ المجغرف ومن الجغرافية المؤرخة”، ويرسي قضاياها المصيرية الخطيرة على اسس فلسفية، أبداً متحركة من ضمن القناعة الأصيلة “لبنان التاريخ أكبر من اللبنانيين”. وهكذا يكون البحث “عن قوة الحق في قوّة الحق”، فلا يكفر اللبنانيون مستقبلاً بقوميتهم، ولا يصيب المؤمنين بها الجبن فيتقاعسون حيال جهرها على سنان الرمح.
يرتبط وجود القومية اللبنانية اذن بدولة لبنانية هي عبارة عن مواريث أدبية وتقاليد حضارية وقيم روحية، أصبحت، بشرعية لا مثيل لها على النطاق الجغرافي والتاريخي والسياسي، نموذجاً للتعايش السلمي، فلسفة مقومنة وقومية مفلسفة، وبفعل تاريخي ميثاقي آل إلى اعتبار الطائفية استكمالاً للهوية اللبنانية وإنتماء، بالتالي، للأمة العربية.
فهذه الطائفية الضحية، التي تمّ تفريغها من بعدها الاجتماعي والإنساني، حوّلها الحاج إلى نعمة التعايش في صيغة الشراكة، تحترم الحق في الاختلاف، وتبعد عن لبنان أسباب “تكسير أضلاعه”، وتفسح له في المجال، أن يتغنّى بعروبته “بشرطين ألّا تكون عروبة دينية وألا تطلب الوحدة السياسية المبرمة” […] “وان يعلن لبنان دون خوف “رفضه قيام دولة مسيحية تختصر فيها القومية اللبنانية”.
ذات يوم في توجيهه الكلام لإبنه يوسف، قال له كمال الحاج ما معناه “لن تعرفني الأجيال حقّ المعرفة الا بعد مضي نصف قرن. أنا لا اكتب لمعاصري. نتاجي هو للأزمنة الآتية”.
لا شك في أن هذا الكلام على جانب كبير من الصحة، لأنه، في زمن التنظير الفلسفي للقومية اللبنانية، في زمن التركيز على لا معنى تاريخ لبنان في حال كان لبنان التاريخ غير مشير إليه من “فوق”، كانت الساحة اللبنانية بخاصة، والساحة العربية بعامة، في “خبصة” من القوميات التي فلتت من عقال التاريخ.
وإن كنا نسجّل على هذه القومية أو تلك شيئاً من ملاحظات، إلا أن تنبؤ الحاج أن لا بديل لقومية لبنانية قائمة، من جهة، على اللغة العربية كفعل التعبير القومي،
ومن جهة أخرى، على لبننة الفلسفة لنفلسف لبنان، بهدف “خلق جيل يتحدّى الغموض، يقهر السفسطة، يتمرجل بالفكر، ويتكلم كمن له سلطان”؛
وأخيراً على التسليم أن لا فوق لنا فوق القومية اللبنانية، وهويتها الدائمة هي النصلامية الجامعة، ولا بعد لنا بعدها؛
هذه النبؤة الكمحجية تستكمل في عظة الصيام، التي ألقاها الإمام موسى الصدر، في كنيسة الآباء الكبوشيين في ١٨ شباط ١٩٧٥، وأبرز ما جاء فيها:
“ها نحن نجتمع بين يديك في بيت من بيوتك[…] دعوتنا لأن نسير جنباً إلى جنب في خدمة خلقك[…] اجتمعنا من أجل الانسان الذي كانت من أجله الأديان، وكانت واحدة آنذاك، يبشر بعضها ببعض …
[ولأنّ]البدء الذي هو الله واحد، والإنسان واحد، […] فحين نسينا هذا الهدف نسينا الله […] وعبدنا آلهة من دون الله […] وتركنا الانسان يتمزق[…] […] ولبنان بلدنا، البلد الذي ثراؤه الأنبل والأخير هو انسانه[…] وكل انسان فيه هو الانسان كله […]، وإذا اردنا أن نمارس شعورنا الوطني وإحساسنا الديني، فعلينا أن نحفظ إنسان لبنان، كلّ إنسان […] [لبنان] هو نموذج للإنسانية الجمعاء […] فلنلتق على الانسان في لبنان : أمانة التاريخ وأمانة الله”.
ربما عندما نجد الطوائف مرتبطة اليوم بمحاور إقليمية تخطّت حدود الدولة، وعندما نلتمس الخوف عند المسيحيين المشرقيين على مصيرهم في الشرق، قد يعترينا شعورٌ أن النصلامية يوتوبيا، ولكن عندما نشهد للإجماع على رذل الأصولية الإرهابية، وعندما تتوافر أفكار تطالب بسيادة العقل المنفتح، وتنسب مثلاً العقل المصري إلى الذهنية المتوسطية، وعندما تتهاوى بسرعة غير مسبوقة ايديولوجيات القرن الماضي، وتتصدّع القوميات اللاإنسانية، وتفرّخ القوميات المتعددة والمتنوّعة بوجه الآحادية المعولمة، والآحادية الأصولية المنافسة، نرى المجتمعات تبحث عن خصائصها وتبعث هويتها، فتعود إلى ذهننا “هذه الذات اللبنانية [الكائنة] في المواضي ولا تزال في الحواضر، وستبقى دوماً في آتيات الزمن”، فتنتفض فينا دعوة الحاج الرسولية القائلة إن ميزة قوميّتنا، على مدى الأجيال، كانت فكراً ومازالت”، ونحن في العودة الثانية ندعو إلى إحياء هذا الفكر الهويتي الذي غيبناه في تاريخنا الحديث والمعاصر.
في العودة الثانية ندعو إلى النهل من الفلسفة التي انطلقت من الذات إلى الذات الأخرى، تشاركها في رأيها وخطابها ونهجها… وعلى مثل هذه المشاركة تبنى العائلة الانسانية الكبرى بالضمّ المتعقلن لا بالنبذ والإنكفاء على الذات، ليعتاد
النظر إلينا أننا لسنا أصحاب الفكر المأزوم والمهزوم، فلن نكون، من الآن وصاعداً، كمن يبحث عن مخرج من النفق المظلم، نحن أهل فكر على مستوى عالمي، ان القومية اللبنانية هي النموذج، بعد النكبتين الاولى والثانية في القرن الماضي، وفي زمن إنهيار الكيانات مطلع الألفية الثالثة، لأنها قومية عقلانية إيمانية قد تشكل نظاماً لإستعادة فلسطين، وتفيد مفهوم التغيير الوطني بعد حروب “الربيع العربي”.
انظروا اليوم إلى لبنان … على أرضه من مسببات الحرب ما يفوق تلك التي أشعلت نيران ١٩٧٥، وما جرته من ويلات ، ومع ذلك، فالنسيج الوطني المتنوّع يكثر من وثائق التفاهم، ويبعد عنه شبح الحرب، والكلّ في فلسفة العيش المشترك واحترام حقوق الآخر، في روحية فلسفة الميثاق الوطني التي يستدلّ منها أن الطوائف تبلغ سنّ الرشد، وتنضج بما فيه الكفاية، وتؤكد مرة أخرى أنه بفضل الدين و بفضل الايمان بالله وبالإنسان، ثمة قومية لبنانية، فلنحافظ جميعنا عليها إرثاً فلسفياً جعل من التعارض تكاملاً لا تضاداً ولا تنافراً، و من السؤال نبض حياة، و من الحرية قيمة لا تؤخذ و لا تعطى بل تبنى من الباطن.
خلاصة
العودة معا الى ورشة العمل الفلسفية لنضيء، مع اصحاب الإرادات الطيبة، شمعة في ديجور هذا الوطن المتعب، ولندع أجيالنا الشابة تعي ما قاله الحاج وما نردده اليوم، وتحدد خياراتها، لتبقى عندنا الفلسفة “الفاتحة” إلى ما أقمَحَت المعارف إلا بها، فما تقمّر ليل شعب، أو تشمّس تاريخ قوم إلا بها.
 أبيض أسود أخبار لبنان، ألشرق الأوسط والعالم – AbyadAswad.com
أبيض أسود أخبار لبنان، ألشرق الأوسط والعالم – AbyadAswad.com