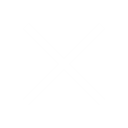أظن وفقاً لقراءتي ولمقاربتي ما يجري على الصعيد العالمي، انّ الإلحاد يشكّل تعبيراً آخر عن ايمان يرفض الايمان الذي يستخدم الله والدين لإقامة المجازر باسم الدين، لتكريس الحقد باسم الله، لاستعباد الآخرين باسم العقيدة والشريعة، إلخ. ان الظاهرة الالحادية هي صنو الظاهرة الأصولية، مع اختلاف ان الملحد قد لا يضطر الى حروب إبادية، في حين ان الاصولية تفصل الانسانية عن جسمها الإنسانوي، وتقسّمه الى دار الأصولية ودار الكافرين، وتجيز لنفسها ما لا تجيزه الظاهرة الالحادية.
وفي عمق المعالجة للامرين، على ارباب الدين، الى اي دين انتموا، ان يقدموا، كما فعل البابا فرنسيس ومفتي الأزهر، على نشر ثقافة التواضع، وثقافة التفاهم، والاعتراف بكرامة الآخر المختلف، وقبول الأخوة الإنسانية، والعمل على الخروج من “كهوف” عقائدية ظالمة الى رحاب الله الواسعة، ولتكن الأديان نوعاً من حدائق أنوار، من مسالك الى الله، تحترم بعضها، ويحترم كل واحد منا الآخر في ما يؤمن به وهنا دور الاعلام في تكريس هذا المبدأ لانه بات شريكا اساسيا بفضل دوره المؤثر ذات الابعاد الفاصلة والواصلة في عالم الميديا والتواصل من أجل الحد من تفكك وتصدع وتصاعد التيارات الارهابية تارة والالحادية من جهة اخرة تسهم في تشويه الواقع المعاني والاهداف وفهمنا لذواتنا وللاخر.
“ان التعريفات للإلحاد هي عمل علمي وفلسفي ولغوي واجتماعي، مرتبط بالمجتمع الملحد، بما ينتمي اليه، وبجذوره الايمانية القديمة قِدم انسانية الملحد المجتمعية.”
الا ان معايير الإلحاد، على تعدّديّتها، متشابهة، متقاطعة، صريحة، وفجّة من حين الى آخر، غير ان الملحد ليس اقلّ انسانية من المؤمن، وليس اقل تفكيراً من المؤمن، وعلى المجتمع فتح باب اللقاء والتحاور مع الملحد المتفلسف، والملحد المتأثر بتطور العلم والتكنولوجيا، والملحد بسبب الوباء المنتشر في أروقة اهل الدين والتديّن، لعلّ في الأخذ والردّ، في تبادل الآراء، كل فريق يتعظّ، ويصار الى نقطة لقاء مشتركة، توضح للملحد انه ليس معصوماً عن الخطأ، ولغير الملحد انه لا يمتلك ناصية الحقيقة وحده، فيتم حينذاك يقظة وصحوة ضمير، تستعيد من خلالها المجتمعات امكانية اعادة النظر في مواقفها الملحدة اوالمؤمنة من اجل بلوغ انسانية الإنسان وتحقيقها على الارض.
اولاً: إن التجربة العلمانية في جذورها انطلقت من منظومة فصل الدين عن الدولة في الشؤون السياسية، وارست شرعة المواطنة المميّزة باعتماد الحرية، الاخاء، والمساواة. وظاهرياً هذه الفلسفة السياسية خرجت من رحم التحالف بين الكنيسة والسلطة السياسية في الغرب، وحرّرت الاثنتين، حرّرت الكنيسة من الانغماس في وحول السياسة، وحرّرت السلطة السياسية من مفهوم السلطة المطلقة الى مفهوم السلطة الديمقراطية والشراكة في الحكم.
ان يكون الهمّ الأول لهذا الحدث التاريخي حياد الدولة، فالأمر، في هذا المفهوم، يكون مقبولاً الى حدّ ما؛ و البرهان دام النظام العلماني قروناً و امتد الى عدد كبير من دول الغرب.
اما ان يصبح النظام العلماني، مع مرور الزمن، واسطة لاستبعاد الله عن الساحة السياسية والمدنية والاجتماعية، ولاستباحة الكنائس وتحويلها الى فواجع بحق الانسانية تسقط بها العلمانية العلاقة الوطيدة بين الكنيسة والدولة، فالمسيحية لا تستغرب إلغاء هذا التحالف، لأن “ملكوتها ليس من هذا العالم”، ولأنّ سيّدها “أدّى ما لقيصر لقيصر وما لله لله”، وحجب عن عيون المسيحيين هذا التسلّط السياسي اللّاغي للإنسان ولله. اما ان يشتهي مسيحيو الشرق، والى جانبهم اقلية من المسلمين المتنورين، نظاماً علمانياً يفصل بين الدين والدولة، فالأمر ليس بغريب، لأن النظام السياسي في العالم العربي والاسلامي، هو بعامة، نظام ديني كلياً او جزئياً، ما يعني ان بين الدين والسياسة حلفاً يصعب تفكيكه، إذ إن الاسلام دين ودنيا في مفهوم المسلمين المؤمنين.
والمسألة الشرقية لا تزال مسألة صعبة بسبب هذا الواقع الديني السياسي، فالمسلمون لا يرضون بالنظام العلماني وبأقصاء الله عن الساحة العامة، والمسيحيون المتمسكون بوطن كلبنان يرضون بالنظام الطائفي لانه يحفظ لهم وجودهم وكيانهم، ويكون الإلحاد فصلاً تسويقياً أو مسألة استهتارية او عملية انفصال عن مجتمع لم يبلغ سن الرشد بعد.. . باختصار علينا تغيير الخطاب الاعلامي من اجل تغيير العقل العربي فلا يجوز اعتماد نفس الاعلام ونفس الروايات والايديولوجيات.
 أبيض أسود أخبار لبنان، ألشرق الأوسط والعالم – AbyadAswad.com
أبيض أسود أخبار لبنان، ألشرق الأوسط والعالم – AbyadAswad.com